#هويات القراءة
Text
عمليات الاحتيال عبر الإنترنت؛ في حين شهد عام 2023 زيادة كبيرة في عدد مستخدمي الإنترنت، فقد شهد أيضًا زيادة هائلة في عدد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، ومع كل عام قادم، سوف يخسر الناس المزيد من الأموال بسبب المحتالين.
في عام 2022، خسر الأشخاص أكثر من 8 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، ومن الجدير بالذكر أن معظم عمليات الاحتيال تتم عبر الويب، ومن ثم، يجب على مستخدمي الإنترنت أن يظلوا يقظين وأن يراقبوا المحتالين الذين يريدون سرقة أموال عامة الناس التي حصلوا عليها بشق الأنفس وذلك من خلال مجموعة متنوعة من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
لا يمكنك عدم استخدام الإنترنت لحماية نفسك من عمليات الاحتيال وخسارة الأموال فهذا أمر غير واقعي، ومن ثم، فإن البقاء يقظًا واتباع النصائح الفعالة التي يمكن أن تساعدك على تجنب عمليات الاحتيال هي الممارسة الصحيحة التي يجب عليك القيام بها. مع ذلك، لا يدرك العديد من الأشخاص كيف يمكن للمحتالين سرقة أموالهم وكيف يمكنهم إنشاء طبقة حماية ضد المحتالين.
توضح هذه المقالة في موقع الأفضل العديد من النصائح الفعالة التي يمكن أن تساعدك على ضمان منع عمليات الاحتيال. ستساعدك قراءة هذه المقالة بشكل كبير على التعرف على الطرق الفعالة للغاية لضمان الأمان ضد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. تابع القراءة معنا لمعرفة المزيد.
ابق على اطلاع
لضمان أقصى درجات اليقظة ومنع عمليات الاحتيال، تحتاج أولاً إلى البقاء على اطلاع دائم بجميع عمليات الاحتيال المختلفة، حيث يحاول المحتالون سرقة أموال الناس باستخدام حيل مختلفة. بالتالي، يجب أن تكون على دراية بممارسات الاحتيال هذه وأن تحافظ على حماية جيدة ضد تلك الحيل، وهنا فإن الوعي بأحدث أساليب الاحتيال خطوة نحو هامة لمنع الاحتيال.
يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة للغاية لك، حيث غالبًا ما يشارك الأشخاص الذين يتعرضون للخداع تجاربهم على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، اجعل من ممارسة قراءة المدونات المكتوبة حول منع الاحتيال عادة لك. سيساعدك القيام بذلك على البقاء على اطلاع دائم بالجديد في هذا الموضوع، ويمكنك حماية نفسك من أي نشاط احتيالي بشكل فعال.
"قد يهمك: مواقع التواصل الاجتماعي"
استخدم البحث بالصور لتجنب صيد القطط
مصطلح "صيد القطط" هنا هو جذب شخص ما إلى علاقة باستخدام شخصية خيالية عبر الانترنت. سوف تتفاجأ عندما تعلم أن المحتالين يسرقون أموال الناس من خلال استدراجهم إلى علاقات مبنية على الرومانسية.
تم الإبلاغ عن وقوع أكثر من 40 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية ضحايا لعمليات الاحتيال الرومانسية في العام 2022، وهذا جعلهم يخسرون أكثر من 540 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يتظاهر المحتالون بأنهم صديق أو أحد أفراد العائلة المفقودين منذ فترة طويلة لصيد شخص ما.
هنا يجب عليك البقاء يقظًا والبحث قبل التفاعل مع مثل هذه الهوية عبر الإنترنت. في هذه الحالة، يمكن أن يكون البحث العكسي بحث الصور فعالاً للغاية في تحديد عملية احتيال صيد القطط، حيث يستخدم المحتالون عمومًا هويات وصور خيالية لأشخاص آخرين.
أنت تستطيع البحث بالصور التي يستخدمها الشخص عبر الإنترنت لإرسالها إليك وتحديد ما إذا كنت تتفاعل مع شخص حقيقي أو هوية خيالية، وفي حال شعرت بوجود عملية احتيال، فتراجع فورًا وأبلغ عن هويتك وما يحدث لوكالات إنفاذ القانون ذات الصلة بمنع عمليات الاحتيال في منطقتك.
لا تصل إلى الروابط المشبوهة التي تتم مشاركتها عبر البريد الإلكتروني
هناك طريقة أخرى يستخدمها المحتالون للاحتيال على الأشخاص وسرقة أموالهم وهي استخدام رسائل البريد الإلكتروني، حيث يرسلون رسائل بريد إلكتروني إلى أشخاص تحمل عناوين جذابة أو عناوين مُربحة. هذه العناوين الجذابة أو العناوين المربحة تُجبر الأشخاص على فتح رسائل البريد الإلكتروني لاكتشاف ما بداخلها.
غالبًا ما تحتوي رسائل البريد الإلكتروني هذه على محتوى يُجبر الأشخاص على الوصول إلى الرابط المشترك. بشكل عام، هم يجذبون الأشخاص لفتح الرابط المحدد من خلال مشاركة عرض عمل مُربح للغاية أو خصم كبير على منتج شائع، كما يمكن أن تكون رسالة دعم فني لمساعدتك في تأمين جهازك، أو غيرها من الرسائل التي يعتقد الشخص أنه سيربح منها.
يقوم الأشخاص الذين يجدون ذلك مفيدًا بالنقر فورًا على الروابط المشتركة بدون التفكير مرة أخرى في خطورة ذلك، وبمجرد النقر على الرابط المحدد، فإنهم يمنحون إمكانية الوصول إلى أجهزتهم للمحتالين الذين يقومون بتثبيت برامج ضارة في الجهاز الخاص بالضحية لجلب البيانات الحساسة من هذا الجهاز للمحتالين.
قد تتضمن المعلومات التي يتم جلبها من جهاز الضحية كلمات المرور للحسابات البنكية وأرقام الضمان الاجتماعي وغيرها
من المعلومات الحساسة، وبالطبع يمكن للمحتالين استخدام هذه المعلومات لتحقيق مكاسبهم وجعلك تخسر المال. بالتالي، لا تنقر على الروابط المشتركة عبر رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة.
"قد يهمك: التنمر الإلكتروني"
تأكد من أمان جهازك أحد نصائح لمنع عمليات الاحتيال عبر الإنترنت
هل تتذكر المثل القديم: "الوقاية خير من العلاج"؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيجب أن تفهم أن هذا القول ينطبق أيضًا على منع عمليات الاحتيال. بمعنى، أنه يجب أن تكون مستعدًا جيدًا ضد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت للوقاية منها، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي ضمان أقصى درجات الأمان، ويمكنك القيام بذلك باستخدام كلمات مرور قوية لحساباتك المالية.
هنا تأكد من استخدام كلمات المرور التي تحتوي على أرقام وأحرف كبيرة وأحرف صغيرة وأحرف خاصة؛ لكونها كلمات مرور قوية يصعب التنبؤ بها. أيضًا حافظ على أمان اتصال Wi-Fi الخاص بك باستخدام كلمة مرور قوية لإبقائه بعيدًا عن متناول عمليات الاختراق. يجب عليك في نفس الوقت توخي الحذر بشأن المعلومات التي ترسلها عبر اتصال Wi-Fi عام، يعني في الأماكن العامة ووسائل المواصلات وغيرها من الأماكن خارج منزلك. كذلك، قم دائمًا بالوصول إلى مواقع الويب المحمية ببروتوكول HTTPS.
بالإضافة لما سبق، احتفظ بمعلوماتك الشخصية لنفسك ولا تشارك أبدًا تاريخ ميلادك أو عنوانك أو اسم والدتك مع الجمهور. أخيرًا، حافظ على تحديث أجهزتك واستخدم أحدث برامج الأمان ومتصفحات الويب وأنظمة التشغيل لتجنب البرامج الضارة، وبالتالي سوف يفيدك ذلك في منع عمليات الاحتيال عبر الإنترنت
تعرفنا في هذه المقالة على أهم 4 نصائح هامة وفعالة من أجل منع عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. تذكر أن ما عرضنا لك من نصائح، هي هامة فعالة لمنع عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وسوف تساعدك في منع وتجنب فقد أموالك التي تعبت فيها.
0 notes
Text
القراءة في الأماكن العمومية ليست جريمة: حوار مع الدكتورة عقيلة طبي والأستاذة إكرام صغيري
القراءة في الأماكن العمومية ليست جريمة: حوار مع الدكتورة عقيلة طبي والأستاذة إكرام صغيري
هذه التدوينة برعاية نشرة الأحد البريدية من إعداد الأستاذ علي عسيري وهي نشرة تشبه قرصات شاورمر لكنها للتسويق. اشتركوا فيها وشكرًا للدعم.
بفضل الله أجريت حوارًا مع الدكتور عقيلة طبي والأستاذة إكرام صغيري؛ وعقيلة طبي دكتورة في التربية وباحثة. تشمل اهتماماتها البحثية القراءة الترفيهية، والهوية، والعدالة الاجتماعية، ومنهجيات البحث الإبداعية. وقد تخرجت للتو من جامعة كانتربري الإنجليزية. وكانت هناك…
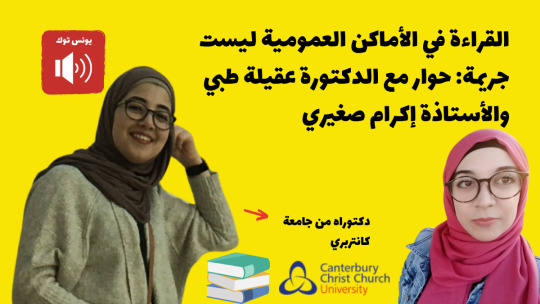
View On WordPress
#يونس_توك#القراءة#ممارسات القراءة#هويات القراءة#هواية القراءة#أبحاث علمية عن القراءة#إكرام صغيري#القارئ المزيف والقارئ الحقيقي#القارئ السائل#المترجمة إكرام صغيري#الباحثة عقيلة طبي#الدكتورة عقيلة طبي#حبل سكاربورو#عقيلة طبي
0 notes
Photo
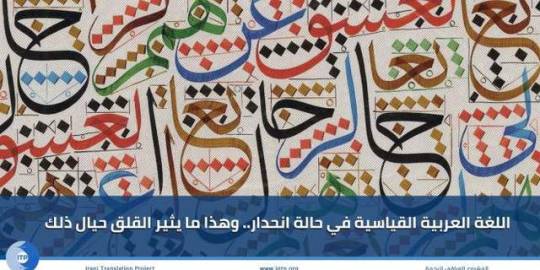
اللغة العربية القياسية في حالة انحدار.. وهذا ما يثير القلق حيال ذلك كتبه لصحيفة (اتلانتيك كاونسل): حسام أبو زهر منشور بتاريخ: 21/5/2018 ترجمة: أحمد الحسيني مراجعة وتدقيق: آلاء عبد الأمير تصميم: مينا خالد تحذيرات كثيرة، تقول إن اللغة العربية الفصحى، أو اللغة العربية الفصحى المعاصرة، في حالة انحدار، بوجود سعادة من البعض الذي يراها تنحدر. ومع ذلك، من المهم ملاحظة العوامل التي تقود هذا الانحدار، وما يعنيه هذا بالنسبة للمنطقة. غالباً ما يرى العرب انحطاط أو انحدار لغتهم العربية الفصحى المعاصرة باعتباره فشلٌ لدولهم في الحفاظ على تراث اللغة العربية، لغة القرآن والإسلام. وعلى الرغم من أن البعض يبتهج بتقوية اللغة العامية، أو ما يسمى باللهجات، كعلامة على الأهمية التي تكتسبها الهويات المحلية، فإن تقهقر اللغة العربية الفصحى، في الواقع، تحذير حول البنية التحتية الاجتماعية الضعيفة والنظام التعليمي المتراجع. قبل المضي قدماً، من الجيد أن نتساءل ما إذا كانت اللغة العربية الفصحى المعاصرة تمر حقاً في الانخفاض. للأسف، لا توجد إحصاءات واضحة نستطيع توثيقها، وعموماً، ما ينظر إليه الناس هي مؤشرات فردية. تستخدم اللغة العربية الفصحى المعاصرة عادة في وسائل الإعلام العربية، والمواقف الرسمية مثل الخطب السياسية، والخطب والنصوص الدينية، والأدب. عندما يتحدث الناس عن انخفاض اللغة العربية الفصحى المعاصرة، فإنهم يشيرون بالعموم إلى انخفاض في الأدب، وإجادة القراءة والكتابة، وزيادة الميل لاستعمال اللهجات أو اللغات الأجنبية بدلاً منها. ومن أهم العوامل الرئيسية التي أدت إلى تدهور اللغة العربية الفصحى هي ضعف الاقتصادات، والحروب، والرقابة على المطبوعات. فمعدلات القراءة والكتابة في الشرق الأوسط آخذة في الارتفاع، باستثناء العراق في السنوات الأخيرة (وربما سوريا كذلك، في حال جُمعت الإحصائيات من البلد الذي سحقته الحرب)، لكن المسوحات القياسية يمكن أن تكون مضللة. فغالبًا ما تبدو الإحصائيات موجّهة باتجاه معرفة “محو الأميّة الفعّالة” فقط، أو القدرة على فهم “توضيح قصير، وبسيط عن الحياة اليومية”. كما يتم الاستناد أيضاً في هذه المسوحات على الاستطلاعات التي تستخدم مقياساً ثنائياً للمتعلمين وغير المتعلمين، حيث يطلب من الخاضعين للمسح الإجابة عن أنفسهم وهكذا يقعون تحت تأثير انحياز اختيارهم الذاتي. ولا تتم معالجة الأسئلة المتعلقة بمستويات مختلفة من معرفة القراءة والكتابة، أو مجموعات المهارات المختلفة مثل القدرة على إنتاج (الكتابة)، أو صياغة نص فاعل، أو القراءة السلبية. وهنا، نجد أنه ليس هناك تناقض في قول إن معرفة القراءة والكتابة الوظيفية آخذة في الارتفاع، ولكن استخدام اللغة العربية الفصحى المعاصرة، في الأدب المتطور والنصوص الأكاديمية، في تناقص. ينشر العالم العربي الآن ما بين 15،000 و18،000 كتاباً سنويًا فقط، وهذا يعادل بالضبط ما تنتجه شركة ”بينغوين راندوم هاوس“ وحدها. كانت مصر في يوم من الأيام أكبر منتج للكتب، والتي يتراوح إنتاجها بين 7000 و9000 في السنة. وعلى الرغم من ارتفاع ناتجها في السابق، إلا أنه انخفض بنسبة هائلة بلغت 70% بعد ثورة 2011، واعتباراً من عام 2016 بدأت “تظهر بوادر الانتعاش”. اليونان تترجم خمسة أضعاف هذا العدد من الكتب إلى اللغة اليونانية. حيث مجموع ما تترجمه اليونان يعادل ما تنتجه 22 دولة عربية مجتمعة. يقول ”عبد الفتاح كيليتو“ وهو كاتب وناقد أدبي مغربي، إن “طلاب الماجستير لا يقرأون أي شيء على الإطلاق”. المحور العربي الرئيسي، لا سيما مصر ولبنان وسوريا والعراق، كلها تعاني. كتب ”نجار عزمي“ رئيس المحررين في صحيفة ”بدون“ يقول: “تحت حكم مبارك، تعثر المشهد الأدبي المصري”. حيث المثقفون مقادون من الرقابة، مثل المفكر المصري ”نصر حامد أبو زيد“ الأستاذ في جامعة القاهرة الذي كتب عن الدين، فقد أعلنت المحكمة أن ”أبو زيد“ مرتد وطلقته من زوجته (حيث لا يمكن أن يتزوج رجل غير مسلم من امرأة مسلمة في مصر). وفي نهاية المطاف، دفعته التهديدات بالقتل إلى اللجوء إلى هولندا لاحقاً. حتى وإن لم يتم حظر الكتاب بشكل رسمي، فيمكن الوصول إليه بطرق أخرى. بعد أن سألنا في العديد من المتاجر في مصر عن رواية محمد يوسف قعيد “لبن العصفور”، وهو كتاب كُتِب باللهجة العامية المصرية، قيل لي إنه غير محظور لكن المكتبات لن تتاجر به لأنه مثير للجدل. سوريا والعراق كلاهما يعانيان من الحروب. سوريا، التي عرفت في وقت سابق بأكاديميتها العربية لدراسة وتطوير اللغة، وكذلك لحقيقة أن نظامها التعليمي الجامعي بأكمله كان باللغة العربية، هي الآن مدمرة. يجد اللاجئون أنفسهم في بلدان لا تستخدم فيها العربية في التعليم. حتى لبنان المجاورة، تستخدم اللغة الإنجليزية والفرنسية في نظامها التعليمي. تضافر هذه العوامل أدى إلى إضعاف الطبقات المتعلمة من أولئك الذين سيقرأون ويكتبون باللغة العربية الفصحى المعاصرة في البلدان العربية. فغالباً ما تتحدث الطبقات المتعلمة، أو من هي قادرة على التحدث عند الحاجة، بلغة عربية مثقفة، ما وصفه عالم اللغويات المصري ”سعيد بدوي“ بـ”العامية الفكرية” ليُبين أنها أقرب إلى اللغة العربية الفصحى من خطاب الأشخاص الأقل تعليماً والأميين. ما يحدث اثناء عملية هجرة العقول عادة هو انتقال الأفراد ممن يمتلكون المقدرة إلى الخارج، لتجنب الحروب، والعثور على عمل، وتأمين مستقبل أطفالهم. حتى أولئك الذين لا يغادرون في كثير من الأحيان يفضلون لغات أجنبية على اللغة العربية الفصحى المعاصرة، فهم يرون ان اللغات الأجنبية عملية أكثر، ومرموقة، ومن المرجح أن تضمن لهم وظيفة. غالباً ما يعمل الشباب في جميع أنحاء المنطقة بلغة أجنبية غير مستخدمين للغة العربية الفصحى المعاصرة. وأفاد حرم جامعة نورث وسترن في قطر مؤخراً أن معظم طلابها غير ماهرين بما فيه الكفاية في اللغة العربية الفصحى المعاصرة للعمل والظهور على قناة الجزيرة. وأفادت تقارير أن الشباب العربي الخليجي يستعملون اللغة الإنجليزية أكثر من العربية في المنزل. تعاني العربية المعاصرة أيضاً بسبب كيفية إدراك العرب لها. فغالباً ما يُنظر إليها على أنها تستخدم في المواقف الرسمية (وفي الحقيقة تسمى أحياناً اللغة العربية الرسمية)، إلا أن السياق يكشف أن مع استنزاف الطبقات المتعلمة، تنحصر استخدامات اللغة العربية الفصحى أكثر فأكثر للسياقات السياسية والدينية، والتي غالباً ما ترتبط بالنُظم الظالمة والمحافظة. أما الأدب فهو مادة ثقيلة عموماً، فهناك عدد قليل من المؤلفات الخفيفة مثل “كتب الشاطئ” أو غيرها من الأشكال المسلية للأدب مثل الروايات المصورة، المنشورة باللغة العربية المعاصرة أو العامية. في المقابل، تُقدم العروض التلفزيونية والأفلام الأكثر شعبية باللغة العامية. أما على مواقع التواصل الاجتماعي فاللهجة هي المهيمنة، على الرغم من أن العربية الفصحى المعاصرة تستخدم أيضاً. ومن المثير للاهتمام، أن كانت هناك بعض الجهود لإعادة تنشيط اللغة العربية الفصحى المعاصرة، ولكن في مواجهة تراجع الاقتصاد، والحروب، والرقابة، فإن هذه الجهود من غير المحتمل أن تكون كافية لإنقاذ اللغة. بعض أفلام ديزني تُطلق باللغة العربية الفصحى بدلاً من اللهجة المصرية، والأخيرة كانت تُستخدم في كثير من الأحيان، مما يجعلها تصل بشكل أكبر للأطفال في أفلام الكارتون. كما يتم نشر بعض الروايات المصورة باللغة العربية الفصحى، ومع ذلك، تعاني هذه المنتجات من نقص إمكانية الوصول، لذا من غير الواضح ما إذا كانت ستستمر بسبب الوضع الاقتصادي على المدى الطويل. على سبيل المثال ”همفري ديفيس“ المعروف بترجمته للأدب العربي، يقول أنه في الوقت الذي كانت فيه القصص المصورة والرسوم الهزلية ناجحة بشكل كبير منذ ثورة 2011 في مصر، إلا أنها كثيراً ما تخضع للرقابة بسبب كونها “مباشرة بتأثيرها البصري”. بشكل عام، تُظهر منطقة الخليج إدراكًا متناميًا بأن الاهتمام بـ اللغة العربية الفصحى المعاصرة، غير موجود، ولكنهم لم يقترحوا حلولًا واقعية. وعرضًا لسخرية الموقف، نرى أن الكثير من وسائل الإعلام (المقالات ومقاطع الفيديو) التي تتحدث عن التراجع، تكون باللغة الإنجليزية. كما وُجدت بعض الدراسات التي تبحث في كيفية تحسين التعليم العربي، لكنها تتطلب تغييرات اجتماعية وبيروقراطية هائلة لا يمكن تنفيذها بخفة وسهولة. إن تدهور اللغة العربية الفصحى المعاصرة، يجب أن يُقلِق صانعي القرار. فهو يظهر انحدار الطبقات المتعلمة وفشل الحكومات العربية في إنشاء أنظمة تعليمية قادرة على تلبية احتياجات ناخبيهم. وعلى الرغم من أن البعض يحتفل بالاستخدام واسع النطاق للّغات العامية في وسائل التواصل الاجتماعي، كعلامة على الهويات المحلية التي تنتصر على الهويات “الأم”، فإن هذا الأمر يجب أن يُقابَل بحذر. فالهويات المحلية للّغة، ليست بالضرورة هويات وطنية، لكنها في الغالب أدنى من كونها وطنية، لأنها تُظهر فشل الدول العربية في توحيد شعوبها بدلاً من إظهار تماسك وطني قويّ. وحتى إذا كانت اللهجات تنمو بشكل بارز وتصل إلى مرحلة تساوي فيها اللغات الرسمية للدولة -وهي نتيجة غير مرجحة بالنظر إلى المكانة المرموقة التي يمنحها العرب إلى اللغة العربية الفصحى المعاصرة- فإنها تُنشئ تحديات أخرى. إذ لم تطوِّر اللغة العامية أبداً مفردات تقنية بالطريقة التي تتبعها اللغة العربية المعاصرة، وهذا الأمر يوجب تنقيح نظم التعليم بالكامل لتدريس اللهجات. الرواية حالكة، لكن هذا لا يعني أن الوضع ميؤوس منه. ففي الماضي، عندما كان الاقتصاد أقوى، كانت الدول العربية قادرة على بناء طبقة متعلمة تجيد استعمال اللغة العربية الفصحى المعاصرة، ومع ذلك، دون الاستثمار في شعوبها، ودون بذل جهود متضافرة لتغيير دفة الثقافة نحو العربية، ودون مراجعة نظمها التعليمية لبناء جسر أفضل بين اللغة العربية الفصحى المعاصرة واللهجات، فإننا سنستمر، على الأرجح، بمشاهدة انخفاض في اللغة العربية المعاصرة، مما يعكس تراجعاً أوسع لها في المنطقة. المقال باللغة الإنجليزية: هنا التدوينة اللغة العربية القياسية في حالة انحدار.. وهذا ما يثير القلق حيال ذلك ظهرت أولاً على Iraqi Translation Project.
0 notes
Photo
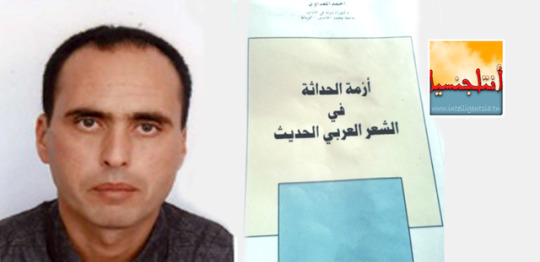
قراءة في كتاب د.احمد المعداوي: أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث شعرية بكر تشفع لها متاهات التجريب (قراءة في كتاب د.احمد المعداوي: أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث ). احمد الشيخاوي/ كاتب مغربي في البداية ،تجدر الإشارة إلى أن ثمة كتب من الأهمية والقيمة العلمية بمكان، ليُنفض عنها غبار النسيان،ينبغي تحكيمها في تعديل وتقويم مسار المشهد الإبداعي العربي، الشعري منه على وجه التحديد. نظرا لصمودها و استعصائها على عوامل التعرية وتبوءها لرقعة شموخ وأنفة ضمن أرشيف خلود الأسماء ذات الثقل في هذا المجال، ومن ثمّ تنفّسها أبدية الإشراق والحضور وإن في الزوايا الأشد عتمة على رفوف المكتبات في زمن استفحال ظاهرة العزوف عن القراءة وهجرة المطبوع بشكل كارثي لافت. ولسنا هاهنا نسجل انحيازا إلى صفّ أصحابها تعصّبا أو انبهارا أو تلبية لهوى يغلي بين الحنايا ،بقدر ما الحافز في ذلك بدرجة أولى، كامن فيما اتسمت به تلك الاجتهادات المضنية من مصداقية وموضوعية راعت إبرازا كاملا وجليّا لحقائق راوحت ما بين محطات الطّمس والتعمية من جهات معيّنة ،لها مصلحة في ذلك، عن حسن أو سوء نية، لا يهم. لعلّ الباحث المغربي الدكتور احمد المعداوي،إذ ذيّل أطروحته القيمة هذه والتي نحن بصدد تقديم عصارتها للقارئ اليوم، ووشمها بقوله: "منذ البداية ،كنت أعرف أنّ أذى كبيرا سينالني، من قبل أولئك الذين اعتادوا أن يتاجروا بالترويج لهذه الحركة والنفخ في رموزها.كنت أعرف مثلا أن أقلّ ما سأرمى به هو السقوط في السلفية،وأن فشلي على صعيد الإبداع الشعري،من حيث نجح غيري نجاحا باهرا،هو السبب في توجهي هذه الوجهة الهدّامة. ومع ذلك فقد وجدت في مواقف وآراء بعض الشعراء والنقاد الشّرفاء من أمثال محمود درويش ،وجبرا إبراهيم جبرا، وإحسان عبد القدوس ،ونزار قباني،وصلاح عبد الصبور،وعبد المعطي الحجازي، وأمل دنقل، ومحمد الفيتوري، وشفيق الكمالي،وغيرهم ، ما ساعدني على الاستمرار في البحث ،من أجل تحويل انطباعاتهم،بخصوص أزمة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، إلى حقيقة موضوعية،يقف خلفها منهج تاريخي يتسقّط الأخطاء وينبّه إلى ما خلفها من مصالح وأهواء،ومعرفة كافية بتاريخ هذه الحركة و ما لابسه من صراعات إيديولوجية وفكرية وفنية. و أدوات إجرائية حديثة يسّرت تحليل المتن،والوقوف على مستغلقاته،على نحو ما فصلنا القول فيه في الفصول الثلاثة التي استغرقت جسد الأطروحة.وكل ما نرجوه أن تكون خدمة الحقيقة من وراء ما قصدنا إليه." انتهى كلام الدكتور، ولعله كان يتطلع وقتها ، إلى ما يمكن أن يثير الزوابع وردود الأفعال الحاقدة والتي قد تقتصر من حيت الفاعلية ومدى الاستفزاز على طرف بحدّ ذاته دون سواه، جراء المساس الجريء بقدسية صروح شعرية ونقدية شيّدها أصحابها وأقاموا حولها من المتاريس والعسس ما يكفي لقمع أي بادرة تتساءل عن مدى صلابة أو هشاشة الأرضية التي شيدت عليها كتلك الصروح،مثلما هو مذكور في غلاف الأطروحة ،و بما الإشكالية في جوهرها، بحث قيم رام إلى تفجير واقع أزمة الحداثة فيما يلامس لبّ الشعر العربي، آنذاك، أي لما يختزل ثلاثة أجيال،ما قبل صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب، سنة1993،منشورات دار الآفاق الجديدة،الرباط ،المغرب. الأطروحة تنطلق من أوج حقبة التحامل السياسي على الثقافة العربية عموما،من اليمين إلى اليسار،منذ تأسيس منابر للحركة الشعرية في تياراتها الثلاثة وتباعا، الآداب البيروتية ،و شعر، والثقافة الوطنية. وهي تثبت بالبراهين والأدلة القاطعة ،كيف أن الحركة اصطدمت بنفق مسدود في النهاية،برغم الفخفخة الإعلامية التي حضي بها رموز الحركة وقتذاك. وتتناول بالدرس والتمحيص فصولا ثلاثة هامة للتدليل على أزمة الحداثة الشعرية، عبر تسليط الضوء على تجارب إبداعية عدّة، وتدحض بالحجة والمنطق ادعاءات أصحابها ومن وراءهم من نقاد ومؤيدين،وتنفي زعمهم القائل بتطوير الشعرية العربية،على مستويات ثلاث كما سنتطرّق إليها تباعا في ورقتنا هذه. وتبطل تلك الاجتهادات المزعومة وتنسب الفضل إلى رواد سابقين ضلعوا فيما تزعمه رموز تلك الحركة من تطوير وابتكار وخلق لمشهدية شعرية بكر تشفع لها تباشير البياض، مثلما جرى على لسان الدارس أحمد المعداوي، من كون تلك البصمات إنما تعود جذورها إلى قرون خلت من الشعر العربي وعلى أيادي الأوائل الذين يعود عهدهم إلى بدايات القرن الحادي عشر للهجرة،وأن ما توهمه رموز الحركة ومن حذا حذوهم ، إنما هو من سبيل جهل النقاد وسوء تقديرهم في مقاربات تجارب الرموز ،وهي صرامة وقسوة مبنية على تعارض وتناقض مواقف الرموز أنفسهم،وصفعة نقدية تلقّتها أسماء بارزة من قبيل أدونيس والبياتي وجبران خليل جبران ونازك الملائكة وغيرهم. ولم تنتصف إلاّ لثلّة من عيار الشابي و شوقي والعقاد و السياب في تجاربهم المختمرة الواعية. عالجت الأطروحة ابتداء ، البنية الإيقاعية، وجدلية الكم والنبر،إبان أولى ملامح القطيعة مع البيت المقفى،وهجرة العمود إلى رحاب التفعيليّ، وكشفت مغالطات كبيرة وخطيرة جدا، أضرّت من حيث لا تدري بديوان العرب وجرّت إلى مستنقع السطحيات والتلاعب بالذائقة وإقصاء المتلقي وتشويه النظم الجمالية للقصيدة أو النص الشعري. وانتقلت إلى البنية اللغوية، لتخلص إلى أنها هي الأخرى طالتها تحريفات واحتكاكات تجارية أجهضت فحوى الأدبيات المستوردة والدخيلة،ما أفقدها مصداقيتها و أبان عن عدم أهليتها ومطابقتها لمعطيات ومسلّمات البيئة العربية،وبالتالي شلل في المعنى الممكن أن يحقق القفزة المرجوة بالشعرية،خارج العوالم العروضية كما هي من منظور خليلي بحث ،والتي لم يشهد مثيل لجماليتها وعذوبة تعبيريتها ، برغم نقر حيز أفسح ،ربما لحراك وصولة المخيلة الشعرية،داخل أفلاك الحركة الجديدة. وقس على ذلك مثالب لا حصر لها،انتهكت خصوصيات الرسالة الشعرية ،اللهم إذا استثنينا نصوصا قيمة نادرة جدا وتكاد تعد على رؤوس الأصابع. وحسب الأطروحة دائما، تعزى أسباب السقوط في مشهدية بلا حداثة شعرية ، لتلك الحركة، إلى عنصرين أساسين، الانبهار الأعمى والترجمات التجارية الصرفة،بحيث أنه مثلما تطبّع كل من عبد الله راجع و محمد بنيس بجاك كوهين ، تأثر آخرون على امتداد الربوع العربية أيضا، بالتجربة الغيرية في هذا المضمار، حدّ الاجترار والإسفاف والتبعية العمياء. فتغلغلت في روح تجارب الحركة، هويات أخرى متناقضة ومتضاربة تماما،لا علاقة للعقل العربي بها على الإطلاق،ما أنتج شعرا فجّا سرعان ما لاقى خفوتا وزال بريقه ، على موسوعية انتشاره،أولّ الأمر. بحيث كثر الحديث عن تجارب الغربة وجدلية الحياة والموت ومتلازمة الأضداد وما إلى ذلك من النظريات المستوردة. كما خلخلت الأطروحة قناعات كثيرة لبسها الزيف لفترات متقطّعة، وأدلت كيف أن شاعرا من طراز بدر شاكر السياب، اعتمد وإلى حد بعيد ، على النفس التقليدي في بناء متون شعريته، بحيث اتضح تشربها التكرّر لرواسب المدرسة الرومانسية كما هو معلوم. والحاصل أيضا ، مع كل من أمل دنقل وسعدي يوسف ، في اعتقادهما حدّ اليقين، بضرورة تقريب اللغة من حديث اليومي، حدّ إذابة المسافة والفواصل بينهما، بغية تحقيق القفزة النوعية المرتجاة. فيما قوربت الظاهرة النّزارية ، نسبة إلى نزار قباني، وحوصرت بنعوت الظاهرة الهجائية، والتي كان خنجر سمّها الزعاف، في صدر الشعوب العربية المغلوبة على أمرها ، أعمق وأبلغ أثرا منه، في صدور الحكام وذوى الزعامة،بعد قضاء ربع قرن ،من قبل هذا الشاعر في شتى مناحي تأليه جسد الأنثى، والعسكرة خدور النساء المخملية، يداعبهن ويتغزلّ بكل نواة فيهن، ويُشْطِط في وصف التضاريس الجسمانية للنوع الناعم، حدّ الخلاعة والتّهتك والمجون، قبل أن يحدث و تصفع صاحبنا، نكسة حزيران، والتي اتخذها كغطاء،لربما، في الانزياح بشعريته عن اللذة والجنس والمطاردات الإيروتكية ، إلى جغرافية الحرف المتمرد والناري داخل حدود أسلوبية ، ترخي بثقل المعنى وجبروته ، ألوانا وظلالا من الهجاء المنصب على الحكام والجماهير على حد سواء ،وكقناع لغضب لم يتمالك معه النفس ،فجّره فيه اغتيال بلقيس.وأتباعه فيما بعد ممن استباحوا معجم الجنسانية،إلى حدود اصطدامهم بالنفق المسدود أخيرا ودون سابق تخطيط. وتفضح الأطروحة مواضع عدة من رداءة الشعرية العربية، على يد الحركة المذكورة، والتي توهّم روادها،وعلى سبيل التضليل، حيازة خصيصة الخلق وابتكار أسلوبية لم يكن لها أصل ولا جذور في تاريخية القصيدة على هيأتها وقوالبها الأولى، بما هو نسف لأمجاد جاهلية ما حادت عن السباحة الطوباوية في مثل تلك الأفلاك الوارفة بنضارة وعمق الابداع. على رأس قائمة هؤلاء، رموز معيارية من حجم أدونيس،والكوكبة المعاضدة له ،من شعراء ونقاد ،من حجم خالدة سعيد وبنيس ومن حذا حذوهما. هي بالفعل مرحلة كبوة عرفتها القصيدة العربية وبشكل قياسي،ومرد ذلك مثلما صرح به الباحث احمد المعداوي ، إلى الوهم الذي تباهت باستيراده تلك الفئة الضالة،على عبثيته وعدم مطابقته للثقافة والبيئة العربيتين. ومن حيث الأزمة ، نفاذ إلى روح الشعرية الأولى وتجميد مكوناتها العضوية، بالاتكاء على أقنعة واهية تمثلت بالأساس فيما يصطلح عليه منعطف تحول إيقاعي،وتسجيل لتباريح حقبة الانتقال من البيت العروضي الصافي، إلى أفق تعبيرية وإن زعمت اتساع وشساعة منحة حرية القول الشعري، فقد ضاقت وعلى نحو مخز جدا، بالمعنى والجماليات التي رصّعت على مدى أجيال متعاقبة، تواز مبهر مابين جمالية و عرفانية ديوان العرب. إنها روح ما أحوجنا إلى العودة إليها، بغرض الاغتراف من نبعها السلسبيل الرقراق،وانثيالها في حقبتها المثالية، التي ازدهرت وأثمرت ما أشفى الغليل ،قبل أن يلحق بها عار اغتصاب من توقيع فيروس قاتل،من إلهام المسماة قصيدة تفعيلية،تعتمد عروضا جديدة، هي إذا ما أمعنا النظر في حيثياتها، مجرد لعبة مراوغة ومنتهجة لهوية دخيلة ومصطنعة،مشبعة بخصوصية الغيرية وضلوع ثقافتها وأدبياتها، و داحضة ومفنّدة لنظريات السبق ونفي إنجازات واجتهادات روح الشعرية العربية الأولى. وهو ما صعق الحداثة في الصميم،وكرّس لوهم تمّ تداوله على نحو مُنحت معه القداسة والشرعية الزائفة لبعض رموز الحركة. تذهب الأطروحة إلى ما يؤيد هذا في مواضع مكثفة بعلمية البحث وحياديته بناء على شهادات وآراء متضاربة صادرة عن نخبة من المنتمين للحركة بعينهم، وإن لونتها نبرة السياقات المختلفة ذات المضمون الواحد المكرور، والمفضي بالنهاية إلى التشكيك القاسي في حداثة الشعرية،ووضع آل الزعم بها، في قفص اتهام فوّت على القصيدة الشيء الكثير وهبط بها إلى أبشع صور الانحطاط، وانحدر بها إلى مزالق الأنفاق المسدودة ، إلاّ في من ندر. وإبرازا لحساسية الورطة التي صادت خيوط سمّها رواد الحركة،وفق موجبات أفتت بلحظة دقّ ناقوس الخطر والخروج عن الصمت وترجيح كفة المنطق والعقل والجرأة وخدمة الحقيقة،جاء هذا البحث الموسوعي القيم،لا ليفجّر إشكالية بنكهة درامية فحسب، إنّما ليزكي سائر ما يساير التحولات المتناغمة و روح الشعرية الأولى بما هي ترجمة حقيقية وغير تجارية لواقع وحياة وتكوينية هوية وشخصية الإنسان العربي حيثما حلّ وارتحل. ومن حيث أنها لا أوجه للجدة تذكر في تاريخ هذه الحركة التي طالما تغنّت وأشادت بالبيت الحر في بداية تجلياته وبوادره الأولى،وكيف أنه إذا ما استثنينا النزر القليل من تلك الأعمال الأدبية بالطبع، جاز لنا الإقرار بالفشل الذر يع الذي تجرّعته الحركة في تجريبية انزياحها عن أصول العروض ومحاولة تجاوزه إلى عروض جديد وغيار لم يُصب حظا سوى الخروج علينا بإسراف في التنويع على المعاناة و القافية وتركيبها وإرسالها، و اشتغالهم على آلية التدوير والمزج ما بين البحور الخليلية ،وهو فعل أو ممارسة ضاربة بنواتها في عمق الشعرية العربية،كما هو معروف ومعهود في شعراء البند،على سبيل المثال لا الحصر،الحاصل مع صالح الجعفري في مثيل قوله: تجلّى أمسُ للعشّاق فاجتاح قلوبا شفّها الوجدُ/ وزادتها التّباريحُ شجونا/ فما رقَّ ولا لانْ/ولا جازى بإِحسانْ . وتعميما للفائدة ، نختم بالدمغة البحثية التالية:الواقع أننا لم نكن بحاجة إلى هذه التساؤلات كلها، لو لم نجد النقاد والباحثين في الشعر العربي الحديث، بمن فيهم الشعراء أنفسهم،يلحون كل ذلك الإلحاح، على أن البنية الإيقاعية الجديدة إنما قامت على أنقاد البنية الإيقاعية التقليدية ، وأن ثورتهم الإيقاعية العظيمة كانت الخطوة الأولى في سبيل دخول صوت الحداثة من بابه الواسع، وما ذاك إلا لإيماننا العميق بأن عظمة الشعر في كل زمان ومكان لا تتحقق بمجرد ثورة الشعراء على القوانين العروضية، قديمة كانت أو حديثة. وإنما تتحقق تلك العظمة بما تزخر به إبداعاتهم من شعرية ، لأن الشعرية لا تتوقف على الإيقاع وحده ، مهما حاولنا تثوير قوانين هذا الإيقاع لتتجاوز أو تتخطّى أو تفتت ما كان معروفا قبلها من ضوابط وقوانين.ولعل أكبر خطأ وقع فيه النقاد والباحثون وحتى الشعراء المحدثون، هو أنهم برغم الشعارات التي أكدوا من خلالها على عدم الفصل بين الشكل والمضمون حينا، وبين الدال والمدلول حينا آخر،قد تعاملوا مع البنية الإيقاعية الجديدة كما لون أنها جزيرة معزولة في بحر الحداثة،فكأن هاجسهم الخفي وهم يكتبون عن بنيتهم الإيقاعية الجديدة إنما كان نسف عروض قديم وإقامة عروض جديد، بحيث يمكن القول بأن وراء كل واحد منهم يكمن خليل صغير،يدل على ذلك بالوضوح الكافي،العناوين الفرعية لأبحاثهم فمن " نحو بديل جذري لعروض الخليل" إلى " الأسس اللغوية لموسيقى الشعر" إلى " الشعر الحر ظاهرة لغوية" إلى غير ذلك مما يؤكد أن المهمة لم تكن هي القيام بعمل نقدي هدفه الكشف عن شعرية الإيقاع.". وما ينطبق بهذا الخصوص على بينية الإيقاع ينطبق كذلك على كل من البنية اللغوية والرسالة الشعرية أيضا. ومما يمكن مؤاخذة الأطروحة عليه برغم قيمتها العلمية وثرائها البحثي، النبوءة التي خانت صاحب الكتاب فيما يتعلق بمستقبل قصيدة النثر،باعتبارها الأوسع شعبية وانتشارا حاليا فيما يشبه تخلّ شبه مطلق لها،من لدن الغريمتين السالفتين، في ترع المشهد و الاستحواذ على الساحة ،بصرف النظر عن هاجس التعاطي الجاد وتقديم النوعي فيما يخصّ شعرية قصيدة النثر حاليا من عدمها. يقول الدكتور:"لقد انتبه بعض الشعراء والدارسين إلى هذه الأزمة، بالشكل الذي وصفناه أو بأي شكل آخر، وحاولوا تجاوزها،بأحد اختيارين، أولهما الاعتماد على البصري بدل السمعي،أي بإقحام لعبة السواد والبياض ، وتسخير النقط والفواصل وعلامات الترقيم لتوزيع الدلالة بصريا على جسد القصيدة. وبالطبع فإن هؤلاء لم يضيفوا شيئا إلى جوهر البنية الإيقاعية سوى أنهم استبدلوا بالتغطية البنيوية تغطية سريالية دادائية ،تعطي أهمية كبرى لمتعة البصر على حساب متعة السمع.ومعلوم أن ما هو مطلوب من النص الشعري إنما هو إمتاع الروح بالشعرية لا بالزخرفة، إذ لو صحّ العكس لكان الرسامون والخطاطون من أعظم الشعراء في العالم، ولما كان لكل من أحببنا من شعراء قديما وحديثا مكان في هذه العظمة." ويضيف: "أما الاختيار الثاني فيتعلق بالعودة إلى قصيدة النثر، وهي عودة يرفضها منطق التاريخ الذي يعيد نفسه ، ومنطق الواقع الذي حكم عليها بالموت بعد أن استبدل بها كبار كتابها فنونا أدبية أخرى، كالمسرح على يد محمد الماغوط والرواية على يد جبرا ابراهيم جبرا." وكأن قصيدة النثر عانت وكابدت ظرفية هجرتها وانقراضها الفعلي، كي تنال قسطها من البعث والإحياء ،ولتنقر الحظوة ببشرف عودها الجديد المغاير، وهو ما يشي بمجرّد بث انطباع شخصي نشاز، ولبوس من تخمين غير صائب، وتوقعات في غير محلها وقول مردود على صاحبه ، وإن كان هذا بكل تأكيد ، لا ينتقص أو يقلّل أو يحطّ من شأن الأطروحة في شتى أبعادها العلمية والفنية الفكرية ،كاجتهاد واع ومضن وقائم على البراهين الدامغة في تفجير ملفّ طوّق طويلا بجملة طابوهات أمكنها، ردحا من الزمن ، طمر الحقيقة المرة المشدودة إلى عوالم أزمة ملمّة بروح الشعرية العربية تحت أقنعة متنوعة وادعاءات واصطناع حداثة لا تتفق وهوية وذاكرة وخصوصية الوجود العربي أصلا. إحالة: أنظر كتاب( أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث) للمغربي د. أحمد المعداوي، الطبعة الأولى منشورات دار الآفاق الجديدة الرباط سنة 1993.
0 notes